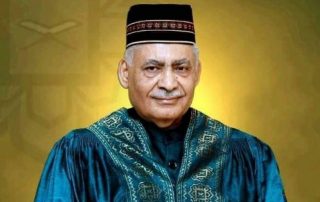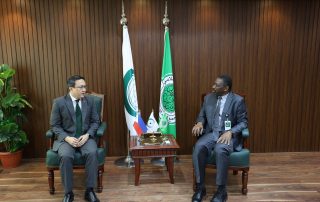د/ محمد الحبيب ابن الخوجة
برعاية في بداية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، نبتهل إلى الله العزيز الحكيم أن يجعله خيرا لأئمتنا وقادتنا، وتطهيرا لنفوسنا، ورحمة لنا، وسبيلا إلى الطاعات والمكرمات، ويقدّرنا على صيامه وقيامه، إنه ذو الفضل العظيم.
وإنا في مواجهة التهجم المتكرر على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم يبدو لنا أنه من المتعين أن نبين حقيقة الدين، وأن نعرف بحقائق ثلاثة، ولعلنا بذلك نصرف الناس إلى اليقين وإلى اتباع الحق الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين في كتابه المنزل عليه القرآن العظيم، وفي سنته الصحيحة المفصّلة والمبيِّنة له. وهذا هو أصح الطرق وأجداها، امتثالا لقوله سبحانه: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).[النحل: 44]. فطريق العلم وسبيل معرفة الدين يرتكزان أساسا على الوحْي إذ جاء في هذا الخطاب دعوة الله لرسوله إبلاغ الناس بما نزل إليهم من ربهم وببيانه لهم، ودعوته للمخاطبين بالتدبّر والتفكّر فيما جاء هم من خالقهم العظيم.
وأحوال الدين أساسا هي ما يجب على المكلّف الإيمان به، وهو التصديق الباطني بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما عُلم به بالضرورة إجمالا في الإجمالي، وتفصيلا في التفصيلي. وإن ما يجب الإيمان به، كما في الحديث، خمسة: الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي بعض الروايات زيادة: القدَر خيره وشره.
فالإيمان الواجب أولا على كل عبد هو التصديق بالله تعالى بأنه واحد أحد لا شريك له، موجود، ليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء، وهو منفرد بالقِدم بصفاته الذاتية والفعلية، فصفة فعله التكوين وصفات ذاته: حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه، وأنه حي عليم قدير سميع بصير، ما أراده جرى. أَحدثَ العالم باختياره، منزه عن الحدّ والضدّ والصورة، لا يكون إلا ما يشاء، ولا يحتاج إلى شيء وهو حكيم عفو غفور.
والإيمان بالملائكة بأنهم أمناؤه على وحيه.
وبالكتب المنزلة بحقيقة ما فيها.
وبالرسل بأنهم أفضل عباد الله.
وباليوم الآخر بشرائعه وتوابعه، وأولُّه حين قيام الموتى، وما بين ذلك إلى وقت الموت هو البرزخ.
والإيمان بالقدر بأن كل ما كان ويكون فبقدرة من يقول للشيء كن فيكون.
وأما الإسلام فهو التسليم الكامل لما جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وهو الشهادتان للقادر عليهما.
وإقامة الصلاة بشروطها وأركانها، وصوم رمضان، بشروطه وأركانه، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، بشروطه وأركانه.
وأما الإحسان فأن تعبد الله كأنك تراه، بعناية المراقبة، وبغاية الإخلاص، والتمسك بالتقوى فإنها السبب الأقوى.
وجملة ما جاءنا من هذه الحقائق والواجبات بلّغنا إياها الرسول الداعي الأمين سيدُنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لنلمس الفارق الكبير بين ما كان عليه العرب في جاهليتهم وبين ما آل إليه أمرهم بعد استجابتهم للدعوة.
يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته عند النجاشي: “كنا نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكلُ القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه.
دعانا إلى الله لنوحّدَه ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات.
وهو مع دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد الخالص حثّ المسلمين على الوسطية، لقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا).[البقرة: 143]. ونهاهم عن الغلوّ في الدين بقوله: “إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين”، وقال أيضا: “إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة”. وقد كان إلى جانب ذلك كله، من الدعوة والنصيحة، متميزا بخلقه الرفيع، شهد الله له بذلك في قوله: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ).[القلم: 4]. وهو الشفيق الرحيم، قال عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ).[الحج: 107]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. ومن شواهد رحمته معاملته لكفار أهل الحديبية الذين أرادوا الفتك بالمسلمين، وكانوا نحو سبعين أو ثمانين رجلا، فتغلب عليهم المجاهدون، وأمسكوا بهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وخلّى سبيلهم دون عقاب، وفيهم نزل قول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ).[الفتح: 24].
وكذلك منعُه ثمامة بن أثال من حبس الطعام عن أهل مكة، وهم أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عفوا منه ورحمة بهم.
ووردت في سورة الأنعام ثلاث آيات (151-153) تضمنت عشرة وصايا، وذلك من بداية قوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ).
وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن الشرك وعلى الأمر ببر الوالدين وعلى النهي عن قتل الأولاد (الأبناء)، وعلى الأمر بالبعد عن الفواحش وبعدم قتل النفس التي حرم الله، وعدم أكل أموال اليتامى، والوفاء في الكيل والميزان، والعدل في القول والوفاء بالعهد. وختمت هذه الآيات بقوله جل وعلا: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
قال صاحب “المنار” تعقيبا على هذه الوصايا العشرة التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه:”إن هذا القرآن الذي أتلوه عليكم، وأدعوكم إليه، وأدعوكم به إلى ما يحييكم هو صراطي ومنهاجي الذي أسلكه إلى مرضاة الله تعالى، ونيل سعادة الدنيا والآخرة، أشير إليه مستقيما ظاهر الاستقامة، لا يضل سالكه ولا يهتدي تاركه فاتبعوه وحده، ولا تتبعوا السبل الأخرى التي تخالفه. وهي كثيرة فتتفرّق بكم عن سبيله بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة، منها ما يُنتهى به إلى الهلكة، إذ ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس أمام تارك النور إلا الظلمات”.
وإلى جانب هذه الدعوة الربانية والتوجيهات السلوكية، البيّن أثرها العظيم في الفرد والمجتمع الإسلامي، دعانا سبحانه إلى حماية الدعوة إلى دينه وإلى نشر كلمته وإلى هداية الناس أجمعين إلى الحق والخير، وذلك في قوله تعالى: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).[الإسراء: 125]، فإن لم يُجد ذلك بسبب اطّراد الظلم للإسلام، والجَور على بلاد المسلمين وأهلها، فإن الله أمرنا بالجهاد في سبيله ووضع لنا آدابا نلتزمها ولا نتجاوزها، وقال:(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ).[ البقرة: 190]. وبين سبب القتال مرة أخرى، وقال: ( فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ).[البقرة: 192]. ووجه عباده في هذا الأمر الجليل منبها إياهم بقوله: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ). و (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ).[الممتحنة: 8، 9].
فالإذن في الحرب كان من أجل الحصول على الحرية في القول والفعل، ومن أجل حفظ الملة والأمة وتخليصهما من كل أذى وعدوان، وقد قيد سبحانه هذا الجهاد بأن لا يكون فيه تجاوز أو تعد أو ظلم، وهكذا بجانب تشريع الحرب قيد التصرفات فيها بالعدل والتقوى، وهذه أصول ومبادئ أجمعت عليها الشرائع ودعا إليها الحكماء والساسة في كل العصور من أجل الدفاع عن الحمى وتحقيق الاستقلال.
وكل هذا يخضع للعلم والحكمة اللذين طريقهما الوحي: القرآن والسُنة الثابتة المتواترة وإلى الحجى أو العقل وقوامهما النظر والفكر، فذلك طريق ينفذ الباحث والدارس منهما إلى الوصول إلى المعرفة الإلهية وغيرها.
ويلفت النظر إلى المصدر العقلي والاهتمام به لدى المسلمين ذكرُ الله له وتنويهه به في غير ما آية. فقد وردت في الكتاب الألفاظ الدالة عليه والكاشفة عن دوره في مثل: يعقلون، وأولوا الألباب، والحكمة والتدبر والتفكر.
فالأولى قوله: (فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ).[الجاثية: 5].
وقوله:(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ).[يوسف: 2].
وخاطب القرآن أصحاب العقول والألباب دعوة وتنبيها بمثل قوله تعالى: (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ).[البقرة: 269].
وجاءت كلمة الحكمة في قوله عز وجل: (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).[آل عمران: 164].
ومن الدعوة إلى التفكر قوله سبحانه: (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم).[الروم: 8]. وقـوله: (الَّذِينَ يَذكُـــرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)[آل عمران: 191].
وجاء التدبر في قوله: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ).[النساء: 82].
ومن هذه الصيغ ودلالاتها وسياقاتها نجد رغبة في التعرف على حقيقة العقل، وهو الطريق الضروري للتمييز والإدراك والمعرفة عند العلماء والمفكرين في سائر العصور.
فالعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، ودعامة المؤمن عقله. فبقدر عقله تكون عبادته، وهو الذي يهدي صاحبه إلى الهدى ويردّه عن الردى. وهو ضروري لا مندوحة من الاعتماد عليه والاستفادة منه.
غير أن اتجاهات فكرية وآراء فلسفية قضت بالإعراض عنه والصدوف عن منهجه في كثير من الدراسات العقدية والدينية. فإن من المعلوم أن ما سبيله النقلُ باعتماد الوحي أصح وأصدق في توجيهات الشريعة ومقاصدها. وهو المعتمد الأصلي في المعرفة. وأما ما سبيله العقل في التوصل إلى الحقائق فإنه لا يكون كذلك فيها لأنه معرض للاحتمال ويغُضُّ منه ما يعرض للعقول من اعتلال.
وقد تفرقت المذاهب والاتجاهات في مجال المعرفة بين أهل الديانات المتمسكين بالنصوص والمعتمدين على النقول وبين أصحاب الاتجاهات الفكرية والعقلية البحتة الذين لا يحيدون أبداً عن طرائقهم العقلية إلى أن جاء الفقيه القاضي ابن رشد وأصدر رسالته “فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال”، وحاول بذلك وضع حد للنزاع بقوله: إن فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالاتها على الصانع أعني من جهة أنها مصنوعات. فإن الموجودات إنما تدل على الصانع بمعرفة صنعها وأنه كلما كانت المعرفة بصنعها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم.
ثم احتج على ذلك بقوله سبحانه: ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَار).[الحشر: 3 ]. وبيّن أن الاعتبار، عمل عقلي، ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه. وهذا هو القياس. فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي. وهو يعتمد في تعليله لحكمه على النظر البرهاني. فإن أدى إلى المعرفة بموجود ما فلا يخلو ذلك الموجود من أن يكون قد سُكت عنه في الشرع أو عُرف به. فإن كان مما قد سُكت عنه فلا تعارض هناك. وهو بمنزلة ما سُكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي، وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق من أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً. فإن كان موافقاً فلا قول هنالك، وإن كان مخالفاً طُلب تأويله. وهذه قضية جديرة بالاهتمام لحل النزاعات واتخاذ المنهج الصحيح الذي يرضي الرب والعقل.
والله من وراء القصد، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اقرأ ايضا
آخر الأخبار