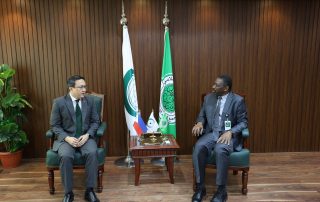شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بعنوان «الدراسات الإسلامية في الجامعات: نحو تعزيز قيم المواطنة والتعايش»، وذلك في الفترة من 28-30 ربيع الثاني لعام 1444هـ الموافق 22-24 نوفمبر لعام 2022م بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويشارك في المؤتمر عدد من خيرة العلماء والأساتذة والباحثين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مبرزين أهمية الدور الذي تضطلع به الدراسات الإسلامية في مؤسسات التعليم في الحفاظ على أصالة الخطاب الديني، وتطوير العلوم الشرعية بما يؤهلها للإسهام في حركة التنمية والتطوير والتجديد والتحديث. ويتناول المؤتمر بالبحث في دورته الحالية ستة محاور تتضمن: الدراسات الإسلامية.. الرؤية والمضمون، الدراسات الإسلامية ومناهج البحث والتدريس، إعادة بناء العلوم الإسلامية في الجامعات العربية، الدراسات الإسلامية وتكامل المعارف، وأخيرا الدراسات الإسلامية وتعزيز قيم التعايش والمواطنة.
هذا وقد شارك معالي الأمين العام في الجلسة العلمية الرئيسية لليوم الأول للمؤتمر ضمن محور “الدراسات الإسلامية: الرؤية والمضمون” وذلك بمداخلة عنوانها “الدراسات الإسلامية وتحديث الدرس الديني” . وفي مستهلّ مداخلته، تقدّم معاليه بالشكر والتقدير إلى قيادة الجامعة على تنظيم وإقامة هذا المؤتمر الهام وحسن اختيار عنوانه، مشيدا بالإنجازات العلمية الكبرى التي حققتها هذا الجامعة الواعدة في فترة قياسية من تأسيسها ، متمنيا لها المزيد من التألق والنجاح، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، المزيد من التقدم والازدهار ودوام الأمن والأمان. ثم أكد معاليه “أنَّ التطوُّر سُنَّةٌ كونيَّةٌ أزليَّةٌ لا تنفكُّ عن أيٍّ فكرٍ إنسانيٍّ أنَّى كان مصدره، وذلك بحسبانه نِتَاجًا بشريًّا يولَدُ من رحم الظروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة، ويكبُر في ضوء الأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة، ويخضَع للبِلَى، فالهرَم، ثم الفناء، كما أنَّ التغيُّرَ هو الآخر سِمَةٌ عاديَّةٌ ملازمةٌ للفكر الإنسانيِّ لا تبرحه، ولا تفارقه، وذلك لكونه أيضًا انعكاسًا طبيعيًّا للظُّروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة السائدة حين تشكُّله، وللأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة القائمة عند ظهوره، مما يجعله دائب التغيُّر والتبدُّل والتحوُّل كما تغيرت الظروف، وتبدَّلت الأوضاع.” وبناء عليه، فأنَّ الفكر الإنسانيَّ “يتشكَّل ويتكوَّن من أجل إحداث تغييرٍ إيجابيٍّ في الواقع القائم، ومن أجل إخضاع ذلك الواقع لقناعاته، ومقرراته، وأهدافه، مما يجعل منه ملاذ كلِّ راغبٍ في التغيير، وملجأ كل باحثٍ عن الإصلاح والتجديد”. وأوضح معاليه “أنَّ قدرة الفكر على تحقيق ذلك الهدف الأسمى من تشكُّله، والمتمثل في إحداث التغيير، مرهونةٌ كلَّ الرهان بما يحتضنه من مضمونٍ ناجعٍ ومحتوىً ناصعٍ مواكبٍ، مستوعبٍ للتطورات والتغيرات التي تداهم الواقعات، تمهيدًا لتطويعها للتغيير المطلوب، والتحديث المأمول، ولذلك، فإنَّ تعهُّده بالمراجعة الدائبة، والتحديث المستمر، والتجديد المتواصل يعدُّ أمرًا ضروريًّا لا مناص منه لكل فكر يروم الاستمرار في توجيه القناعات والمنطلقات، والتأثير في التصرفات والممارسات، والمشاركة في الفعل الحضاريِّ..” ثم عرف معاليه الدرس الدينيِّ بكونه “..فكرًا إنسانيًّا بحسبانه فكرًا أنتجته العقول المسلمة هادفة تحقيق وَصْلٍ أمينٍ بين الوحي الثابت المعصوم والواقع المتغير المتطور، ومتأثرة بسائر الظروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة والأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة التي تتابعت وتلاحقت على الواقع بدءًا بتلك التغيُّرات الكبرى والأحداث الجسيمة التي أثَّرت تأثيرًا واضحًا في الواقع الإسلاميِّ غداة لحاق المصطفى، فداؤه أبي وأمي، بالرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه، ومرورًا بتلك التطوُّرات العظمى التي طرأت على الحياة الإسلاميَّة عشيَّة احتكاك الأمة الإسلاميَّة واتصالها بأمم ذات حضارات فكريَّة قديمةٍ من فرسٍ، وبيزنطيِّين، وفراعنة وسواهم، وانتهاءًا بالتحديات المتعاقبة التي لا تفتأ تداهم الواقع إلى يومنا هذا..”.. وأوضح معاليه بأن ثمة “..أجيالا كثرا من السلف والخلف من خلفيَّاتٍ علميَّة مختلفةٍ، ومنطلقاتٍ فكريَّةٍ متنوعةٍ في أزمنةٍ متلاحقةٍ تتابعت على صياغة هذا الدرس، وصقله، ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون مضمونه ومحتواه عبارة عن مجموعة الاجتهادات والاختيارات التي جادت بها قرائح تلك الأجيال في المسائل العقديَّة (=المتكلمة)، والمسائل الفقهيَّة (=المتفقهة)، والمسائل التربويَّة (=المتصوِّفة)، متأثِّرين جميعًا في سعيهم بظروفهم الاجتماعيَّة والثقافيَّة السائدة، وبأوضاعهم الاقتصاديَّة والسياسيَّة القائمة..”.. وأشار معاليه إلى الفكر الإسلامي الذي أنتج الدرس الدينيَّ كان، قبل عصور التقليد التي ألقت بظلالها على الواقع الإسلاميِّ في نهاية القرن الرابع الهجريِّ، فكرًا حيويًّا متحركًا يجدِّد بناءه على الدوام، ويحدِّث مضمونه باستمرار، وذلك من خلال الترحيب الواعي بكلِّ جديدٍ مفيدٍ، والانفتاح المسؤول على كلِّ وافدٍ سديدٍ رشيدٍ، مما جعل بناؤه قويًّا متماسكًا، ومضمونه متنوعًا متينًا دائم التأثير، والحضور والشهود. ولهذا، فلا غرو، والحال كذلك، أن يكون ذلك الدرس الدينيّ مدوَّنةً زاخرة تضمُّ بين جنباتها وقائع سائر السجالات الفكريَّة التي شهدت الساحة الفكريَّة ذات يوم بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى، ولا عجب من أن يجد الناظر في ذلك الدرس مناظراتٍ بين من عُرِفُوا في التاريخ بأهل السنَّة والجماعة والشيعة من جانب، وبين المعتزلة وأهل السنَّة والجماعة من جانب آخر، بل لا غرابة في شيء في أن يطلع القارئ في هذا الدرس الوافر ذلك السجال المحموم بين طوائف أهل السنة والجماعة من أشاعرة، وماترديَّة، وأهل حديث، وبين طوائف الشيعة من زيدية، وإمامية اثني عشرية، وإسماعيلية.. وأن يجد الناظر فيه سجلًا أمينًا لما شهدت الساحة الفقهيَّة هي الأخرى من خلافات فقهيَّة بين المذاهب السنيَّة والمذاهب الإماميَّة من جهة، وبين طوائف المذاهب السنيَّة من حنفيَّةٍ ومالكيَّةٍ، وشافعيَّةٍ، وحنبليَّة، وظاهريَّة من جهة أخرى؛ وبين طوائف المذاهب الإماميَّة من جعفريَّة وزيديَّة من جهة ثالثة؛ وأضف إلى هذا ما يضمُّه ذلك من وثيقةٍ أمينةٍ لوقائع المناوشات التربويَّة بين المتصوِّفة وغيرهم من أهل القبلة من جانب، وبين طوائف المتصوفة بعضهم بعضا من جانب آخر..” ثم أشار معاليه إلى انحسار الفكر الإسلامي عند أفول شمس القرن الرابع الهجريّ، وذلك “..عندما توَّقف التدوينُ، وانحسر الإبداعُ، وانزوى الابتكارُ، وانفصم الفكرُ عن الواقع المعاش، وظهر في دنيا الناس فجأة تلك المقولة المثبطة للهِمَم “ليس بالإمكان أَبْدعُ مما كان”، وشاعت فتنة القول بإغلاق باب الاجتهاد خاصَّة الاجتهاد المستقلّ والاجتهاد المطلق، فانصرف الاهتمامُ كلُّ الاهتمام إلى الانكباب على دراسة ما أنتجته القرون الأربعة الأولى من علوم ومعارف، وإقامة سياج منيع لحماية تلك الاجتهادات الظرفيَّة الواقعيَّة التي انتهت إليها العقول المبدعة خلال تلك القرون المنصرمة، واعتبارها، على حين غرة، اجتهادات واختيارات واجبة الالتزام والإلزام بها، سواء في المجال العقديِّ أم في المجال الفقهيِّ، أم في المجال التربويِّ. وفضلا عن أن الجهود انصرفت بعدُ إلى شرح ما دونه الأسلاف تارةً، وإلى اختصار المختصر طورًا، وشرح المختصر أحيانًا، فأضحى لتقليد الأفكار والأشخاص صولةٌ وجولةٌ على كافة مناحي الحياة الفكريَّة؛ وبناء عليه، فلم يكن من عجبٍ إذا فارق التجديد وارتحل التحديث والإبداع من ساحة الدرس الدينيِّ، بل لم يكن غريبًا في شيء أن يظلَّ مضمون ذلك الدرس قارًّا على ما انتهت إليه القرون الغابرة إلى يومنا هذا..” وأكد معاليه قائلا: ” إن تمكين الدرس الدينيِّ اليوم من توجيه رشيدٍ للظروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة القائمة، وتسديدٍ أمينٍ للأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة السائدة يحتاج إلى تحديثٍ جرئٍ شاملٍ مسؤول يتجاوز التنظير المجرَّد المكرور، والحديث المملول عن أهميَّة التحديث وضرورته، ويركِّز تركيزًا واضحًا على تصفيةٍ لمسائله، فتنقيحةٍ لموضوعاته، ثم إضافةٍ لمجالاته، تمكينًا له من البقاء والقدرة على التأثير والتوجيه والترشيد. وبعبارة أخرى، إن تصفية مسائل الدرس الدينيِّ تعني الاستغناء المسؤول عن الاهتمام بجملة المسائل العقديَّة والفقهيَّة والتربويَّة التي لم تعد ثمة حاجة إلى الاهتمام بها بحسبانها مسائل تاريخيَّة ظرفيَّة بحتة زالت بزوال الظروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة والأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة التي أسهمت في تشكلها وظهورها، كما تعني تنقيحة موضوعاته القيام بواجب التمييز بين الأصول والفروع والثوابت والمتغيرات في المحتوى العقدي والفقهي والتربوي، والابتعاد عن الخلط بينها، وتعني إضافة مجالات إلى مضمونه تضمينه وتطعيمه بنوازل وتحديات العصر تأصيلا وتحريرا وتوجيها. على أن يكون الاعتصام الرصين بالمبادئ الكليَّة الناصعة منطلقًا، والاستنارة بالقيم الإنسانيَّة النبيلة مستندًا، والاستمساك بمحكمات نصوص الكتاب والسنة، ومقاصد الشريعة منارةً يهتدى بها، وذلك من أجل صيرورة الدرس الدينيِّ درسا مؤثرا وفاعلا ومشاركا..”.. وتحقيقا لهذا، لا بد من “..تحكيم تلك المبادئ والقيم ومحكمات النصوص والمقاصد في محتوى الدرس الدينيِّ يقتضي تعزيز الوعى لدى النشء على أنَّ كلَّ رأيٍ أو فكرٍ يصادر أو يخالف أيَّا منها يجب تجاوزه والاستغناء عنه جملةً وتفصيلاً، كما يقتضي تعزيز وعي النشء بأنَّ ما يجمع بين البشر عامَّة وبين المصلِّين خاصَّة أكثر وأكبر مما يفرِّقهم، وبالتالي، يجب ترسيخُ تعظيمِ الجوامع في أذهانهم، وحثُّهم على الاهتمام والارتقاء بها، كما يقتضي تعزيز وعيهم بأثر الظروف الاجتماعيَّة والثقافيَّة والأوضاع الاقتصاديَّة والسياسيَّة في تلك الأحداث التي عرفتها الساحة الإسلاميَّة عبر التاريخ، وقد اندثرت تلك الظروف، وتبدَّلت تلك الأوضاع، ولذلك، فإن الواقع المعاصر لا يحتاج إلى الانشغال بها، وتحميل غير المشاركين فيها تبعاتها وآثارها، بل اتخاذها، على حين غرَّةٍ، أساسًا لضبط العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الشعوب والأمم من جهة، وبين المصلين أنفسهم من جهةٍ أخرى، والحال أنَّ الماضي ماضٍ له ما له، وعليه ما عليه، والحاضر حاضرٌ له ما له، وعليه ما عليه، والمستقبل مستقبلٌ له ما له، وعليه ما عليه، ولا ينبغي الخلط بين هذه الأزمنة، ولا الخلط بين مكوناته”.
وختم معاليه كلمته بدعوة المؤتمر إلى تبني ثلاثة مرتكزات منهجية رصينة ومتينة لتنقية المحتوى العقدي من الدرس الديني من الأفكار والمفاهيم التي تحول دون تعزيز قيم التعايش والتسامح، وتتمثل تلك المرتكزات في الاحتكام إلى محكمات النصوص والتجربة النبويَّة فيما يتعلق بعلاقة المسلم بربِّه، وبمجتمعه، وبالعالم من حوله، بعيدا عن النظرات التجزيئيَّة التطوعيَّة في ثنايا نصوص الكتاب والسنَّة التي وردت في شأن غير المسلمين عمومًا، وفي شأن أهل الكتاب خصوصًا، إذ تتم في كثير من الأحيان مصادرة العديد من النصوص المحكمات استنادًا إلى تأويلات خارجة عن السياق وأسباب النزول والورود، كما يتمُّ ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض دون التفات إلى منهج التدرج والاستدراج الذي ترتكز عليها تلك النصوص، ويتم الاعتداء السافر أيضا على المبادئ الكلية والثوابت القارة التي أكدت عصمة الأموال والأعراض والعقول بدعوى نسخها بآية مجهولة تسمى بآية السيف، والحال أن النسخ لا يلج بأي حال من الأحوال عالم الأخبار والمبادئ والثوابت، فضلا عما يشهده الناظر في محتوى كثير من محتوى هذا الدرس من مصادرة مكشوفة غير مفهومة للتجربة النبويَّة الثريَّة الواضحة في تطبيق محكمات نصوص الكتاب في تصرفاته، صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، مع غير المسلم سواء أكان كتابيًّا، أم غير كتابيٍّ، كما حدَّدت ذلك كله صحيفة المدينة الخالدة الواضحة. ونتيجة لهذا، يجد الناظر في المحتوى العقديِّ من الدرس الدينيِّ انتعاشًا مذهلاً لتوظيفات غير مسؤولة ولا دقيقة للعديد من المصطلحات الشرعيَّة الناصعة القارَّة ذات مفاهيم محدَّدة، وذات سياقات تاريخيَّة معروفة وواضحة، وعلى رأس تلك المصطلحات: مصطلح الولاء والبراء، والجهاد، والأمان، والحاكميَّة، والجاهليَّة، والكفر، والجزية، والقوامة، وسواها، ويرتَّب على ذلك التوظيف السيء لهذه المصطلحات تبعاتٌ فكريَّة مدمِّرة أقلُّها الاعتقاد المزعوم بكون الأصل في العلاقة بين المسلم وغيره الحرب بدلاً من السلم، والاعتقاد المفترى على الشرع بكون العلَّة في الجهاد الكفر بدلاً من العدوان، فضلًا عن مُحَاصَرة مفهوم الجهاد في الكفاح المسلَّح، وتقسيم العالم إلى دار حرب ودار سلم، بدلاً من دار سلم، ودار عهد.
إنَّ الحاجة اليوم تمسُّ إلى غربلة شاملةٍ لذلك المحتوى العقديِّ الذي صادر مقررات المحكمات، وشواهد التجربة النبويَّة في إرساء أسس وقواعد التعامل مع المخالف في الملَّة والدين، كما تدعو الحاجة إلى تعزيز الوعي بكون الأحكام الشرعيَّة المتعلقة بالأمن والأمان والسلم والجهاد والإدارة والقيادة والحكم والقضاء أحكامًا سلطانيَّة لم يخاطب بها الأفراد، وليسوا معنيين بها، ولا مسؤولين عنها، كما تدعو الحاجة إلى تعزيز الوعي بالمراتب المتعددة والمختلفة لتصرفات النبيِّ العظيم، فداؤه أبي أمي، وذلك من حيث كونها تصرفات محكومةً بما كان يمثِّله، صلَّى الله عليه وآله وسلم، من وظائف متفاوتة تتراوح بين تصرفاته بوصه نبيا، وتصرفاته بوصفه إماما ولي أمر، وتصرفاته بوصفه قائدا أعلى لما يعرف اليوم بالقوات المسلحة، وتصرفاته بوصفه قاضيا، وتصرفاته بوصفه مفتيا..الخ.. ويتمثل المرتكز المنهجي الثاني في تجاوز التركيز على سرد الخلافات والصراعات التاريخيَّة البائدة بين الطوائف الإسلاميَّة، تصحيحا لما دأبت عليه كثير من مؤسَّساتنا على الاهتمام المبالغ في السرد المجرَّد شبه الآلي لأحداث تلك الخلافات التاريخيَّة البائدة التي عرفها الواقعُ الإسلاميُّ سواء منها تلك الخلافات التي وقعت إبَّان وقوع الفتنة بين الأصحاب، رضوان الله عليهم جميعًا، فانقسمت الناس إلى سنَّة، وخوارج، وشيعةٍ، أم تلك الخلافات التي نشبت بين المصلِّين خلال الدولة الأمويَّة والعباسيَّة، فانقسمت الناس إلى سنَّة ومعتزلة، ثمَّ إلى أهل سنَّة وأهل حديث، أم تلك الخلافات التاريخيَّة التي قامت بين أهل الحديث وأهل الذوق والتزكية وغيرهم.
إنَّ هذه الخلافات والنِّزاعات وسواها لا تعدو أن تكون في حقيقتها خلافاتٍ تاريخيَّةً محضةً نشأت بين أبناء الأمَّة نتيجة ظروف اجتماعيَّة وثقافيَّة ولَّت واندثرت، وباعتبارها نزاعاتٍ ظهرت بسبب أوضاع اقتصاديَّة وسياسيَّة انقرضت وانتهت، ولذلك، فإنَّه لا حاجة في واقع الأمر إلى الاهتمام المبالغ في سردها، وترديدها، بل الأليق تعزيز الوعي لدى النشء بأنَّهم ليسوا مسؤولين عما جرى، لأنَّهم لم يعايشوا تلك الظروف التي نشبت بسببها تلك الأحداث، ولم يكونوا أطرافا في تلك الأوضاع التي كانت قائمة، ولذلك، فإنَّ الأجدر بهم الانصراف بالاهتمام بظروفهم الاجتماعية والثقافية القائمة، والتركيز على أوضاعهم الاقتصاديَّة والسياسيَّة السائدة، توجيهًا، وتسديدًا، وترشيدًا؛ ذلك لأنَّه من المتفق عليه لدى جميع العقلاء قديمًا وحديثًا أنَّه لا يوجد اليوم على وجه البسيطة أحدٌ من الإنس أو الجنِّ يعتبر مسؤولًا إن مسؤوليَّةً معنويَّةً، أو مسؤوليَّةً جنائيَّةً عن الآثار الوخيمة التي ترتبت على تلك الخلافات، وبالتالي، فإنَّ استصحابها، والاهتمام بها لا يعدو أن يكون خروجًا على الجادَّة، ومخالفةً لما أرساه كتاب الله جلَّ جلاله من مبدأ رصين متين رزين في النظر إلى خلافات السابقين، أعني أنَّ قوله تعالى (( تلك أمَّة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عمَّا كانوا يعملون))، وقوله عزَّ من قائل: ((ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى)). وقوله تقدس اسمه (( كل نفس بما كسبت رهينة)). فهذه الآيات وسواها في الذكر الحكيم كلها تأصيل وتقرير وتأكيد على أنَّه حريٌّ بالدرس الدينيِّ المعاصر إلإيلاء من شأن هذا المبدأ القرآني الناصع، وتربية النشء عليه، وتمكينه من تمثله فكرًا وسلوكًا وتصرفًا.
وأما المرتكز المنهجي الثالث، فيتمثل في إخراج الاختلاف في المسائل العقديَّة من دائرة الحقِّ والباطل إلى دائرة الخطأ والصواب، تصحيحا لذلك الحضور الطاغي لمصطلحي “الحقِّ والباطل” في كتابات المتكلمة، حيث يوظَّفان لاعتبار الرأي المخالف في المسألة العقديَّة باطلاً يجب ردُّه، كما يُلفِي الناظرُ في المحتوى العقديِّ حضورًا دائمًا لمصطلحات “أهل الأهواء، وأهل الضلال، وأهل البدعة” في كتب المتكلمين، حيث تطلق هذه المصطلحات على المخالفين في المسألة العقديَّة بأهل الأهواء حينًا، وأهل الضلال تارةً، وأهل البدعة طورًا، فكلُّ فرقةٍ بل طائفة تعتبر مخالفيها بأنَّها فرقة ضالة، وأهل ضلال وبدعة، وغير ذلك من الأوصاف المبثوثة في ثنايا كتب العقيدة؛ وفضلا عن ذلك، فإنَّ المتأمِّل في ذلك المحتوى العقديِّ لا يجد صعوبةً في إطلاق كلِّ فرقة أو طائفة على أدلة مخالفيها بأنَّها شبهاتٌ يجب الردُّ عليها، وضلالاتٌ يجب كشف زيفها.
واستنادًا إلى هذه المصطلحات وتوظيفاتها وإطلاقاتها، ليس من عجبٍ أن تنتعش سوق التكفير والتبديع والتفسيق والتفجير في كتابات المتكلمة، وليس من غرابة في شيء أن يكون المحتوى العقديُّ ميدانًا خصبًا ينطلق منها أصحاب الفكر المتطرف في تكفير الموحّدين، وتفسيق المصلِّين، وتفجير الساجدين، وليس من مفاجأة في شيء أن تتخذه الجماعات الإرهابيَّة واحةً كبيرةً يجولون في أرجائها لاستحلال الدماء المعصومة، وهتك الأعراض المصونة، وإبادة الممتلكات المحفوظة، بل ليس من دهشةٍ في أن يتسلل منه سائر المرجفين والمتعالِمين، فيتخذونه أساسًا متينًا لتكفير الأفراد، والحكام، والعلماء، والمجتمعات، والدول.
إنَّ هذا المحتوى يعدُّ عاملًا رئيسًا لحالة التناحر والتنابذ والتناؤش القائمة بين الفِرَقِ والطوائف الإسلاميَّة عبر العصور والدهور، ويعدُّ سببًا وجيهًا من أسباب التقاتل، والتباغض بينهم على مرِّ السنين؛ فضلا عن أنَّه لا يزال حائلًا منيعًا دون أيِّ تعاونٍ أو تضامنٍ أو تكاملٍ بينهم، ولا يفتأ يعمِّق الجفوة والفجوة بينهم.
ومن هنا، فإنَّ تحديث الدرس الدينيِّ في محتواه العقديِّ يتطلَّب به اليوم جراءةً غير مسبوقةٍ متمثِّلة في العمل الجادِّ المنظَّم من أجل تنقية كتب العقيدة وعلم الكلام من استخدام مصطلحي “الحقِّ والباطل” في وصف رأي المخالف في المسائل العقديَّة المختلف فيها بين الفِرَق والطوائف الإسلاميَّة، وذلك التزامًا بالمنهج القرآنيِّ الذي جعل وصف الباطل قاصرًا على مخالفة الهدى، وهو الدين الحقّ، وليس وصفًا للاجتهاد المخالف لغيره من الاجتهادات، وإعمالًا بما نصَّ عليه الحديث النبويُّ الشريف الذي قسَّم المجتهدين في المختلف فيه من المسائل إلى مصيبٍ ومخطئ، ورَصَدَ للمصيب منهم أجرين، أجرَ الاجتهادِ وأجرَ الإصابة، وللمخطئ منهم أجرًا واحدًا، كما ينبغي تصفية ذلك المحتوى من تصنيف المخالفين في المسائل العقديَّة المختلف فيها إلى أهل الأهواء أو أهل الضلال، أو أهل البدع، وذلك اعتبارًا بكون ذلك التصنيف غير موضوعيٍّ ولا دليل عليه من كتاب أو سنَّة، بل إنَّه يخالف ما كان عليه سلف الأمَّة من الصحابة، رضوان الله عليهم، وتابعيهم، رحمهم الله، من احترام لرأي المخالف، واعتراف بحقِّه في الاختلاف.
إنَّ مستندنا في الدعوة إلى هذا التحديث المهمِّ في هذه المرحلة الراهنة من تاريخ الأمَّة يرتكز ارتكازًا على استصحاب المنهج القرآنيِّ في التأصيل لفقه الاختلاف وطريقة التعامل مع المخالف، وما تضمنته السنَّة النبويَّة من أقوال وتقريرات لكيفيَّة التعامل مع المخالف في الرأي والاجتهاد، فضلا عن جملةٍ من القواعد الشرعيَّة القارَّة الناصعة المتفق عليها بين أهل العلم، ومن أهمِّها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقاعدة لا ينقض الاجتهاد بمثله، وقاعدة لا احتساب في المختلف فيه، غيرها من القواعد التي تعجُّ بها كتب القواعد والأشباه والنظائر.
وتأسيسًا على هذا، فإنَّنا نفزع إلى تقرير القول بأنَّ اختلاف أهل القبلة لا يعد اختلافًا بين حقٍّ وباطلٍ، ولا بين أهل هدى، وأهل أهواء، وإنما هو اختلاف يقع في دائرة الصواب والخطأ، وكلهم على هدى، فلا يجوز التحامل عليهم، أو الإنكار عليهم إعمالا بالقواعد الفقهيَّة الآنف ذكرها.
على أنَّه من الحرير تقريره أنَّ المراد بالمسائل الموسومة بمسائل الاجتهاد هي ذاتها المسائل التي تعرف بالمسائل المختلف فيها، كما تعرف بالمتشابهات، وتعرف أيضا بالفروع، وغيرها، ويراد بها جميعًا عند المحقِّقين من أهل العلم تلك القضايا والمسائل التي يصحُّ الاجتهاد أو الاختلاف فيها شرعًا، وذلك لكون النصوص الشرعيَّة الواردة إزاءها ثابتةً بطريقة الظنِّ، أو دالةً على الحكم المراد منها دلالةً ظنيَّة، أو لانعدام نصوصٍ شرعيَّةٍ مباشرةٍ إزاءها؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المسائل التي يصح الاجتهاد أو الاختلاف إزاءها مسائل عقديَّةً، أو مسائل فقهيَّةً، أو مسائل تربويَّةً مادام الظنّ واقعًا في تلك النصوص في ثبوتها أو في دلالتها، مما يعني أنَّ الاعتداد بشرعيَّة الاجتهاد أو مشروعيَّة الاختلاف في المسائل لا يرتبط بكونها مسائل فقهيَّة أو عقديَّة أو تربويَّة، وإنَّما يعود إلى الاعتداد بطريقة ثبوت تلك المسائل بين القطع والظن، أو بطريقة دلالتها على المراد منها بين الظنِّ والقطع، مما يعني أنَّ الاجتهاد أو الاختلاف سائغٌ في كل مسألة ثبت حكمها بطريق الظنِّ، أو دلَّ على المراد منها بطريق الظنِّ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المسألة عقديَّة أو فقهيَّة، أو تربويَّة.
إنَّه من الجدير تقريره أنَّ العلاقة بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف علاقة نتيجةٍ بمقدِّمة، فالاجتهاد مقدِّمة للاختلاف، ذلك لأنَّ الاختلاف في حقيقته ناشئ من الاجتهاد، مما يعني أنَّ انتفاء صلوحيَّة المسألة للاجتهاد يعني انتفاء صحة الاختلاف فيها، إذ لا اجتهاد في المسائل التي ثبتها حكمها بطريق القطع، أو دلت النصوص على حكمها بطريق القطع، وبالتالي، لا يعتدُّ بالاختلاف في تلك المسائل، وتعرف في الدرس الدينيِّ بالثوابت والمعلوم من الدين بالضرورة.
وبناء عليه، فإنَّ التفريق بين المسائل المختلف فيها تعوزه الدقة، والموضوعيَّة، ولا يستند إلى دليل أو منطق مادام المسألة المختلف فيها محلَّ اجتهادٍ، ونظرٍ سائغ في الشرع.
وصفوة القول، إنَّ الاعتداد بالاختلاف في المسائل الموسومة بالمسائل العقديَّة بوصفه اختلافًا طبيعيًّا لا يختلف بأي حال من الأحوال عن الاختلاف في المسائل الموسومة بالمسائل الفقهيَّة، فكما لا يترتب على الاختلاف في المسائل الفقهيَّة تكفيرٌ أو تفسيقٌ، أو تفجيرٌ، فكذلك، ينبغي ألا يترتب على الاختلاف في المسائل العقديَّة تكفيرٌ، أو تفسيقٌ أو تفجيرٌ.
إن الأمل معقود في أن تحظى نتائج وتوصيات هذا المؤتمر بالقبول والاعتبار والتحقق تخفيفا من حالة الرهق الفكري، والتشتت المعرفي، والتفرق السلوكي بين البشر عامة وأهل القبلة خاصة. وما ذلك على الله بعزيز.
وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون ببناء رؤية وطنية قيميّة وأخلاقية، تنظر إلى الوطن بروح الحبّ والوفاء والصدق والأمانة والمواطنة الصالحة، فترعى حقّ ولاّة الأمر، وتذود عن الوطن وتحترم قوانينه، وتحافظ على مكتسباته الفكرية والثقافية والإنسانيّة والاستراتيجية. كما أوصى المؤتمرون بتنظيم ورش شبابيّة محليّة ودوليّة لطلبة الدّراسات الإسلاميّة حول موضوعات المواطنة والتّعايش، واستحداث أقسام لتدريب أعضاء الهيئة التّدريسيّة وفق أحدث مناهج التكوين في طرق التدريس الجامعي والبحث العلمي، وتخصيص منح بحثيّة لتحفيز الباحثين على إنجاز بحوث موسّعة في موضوع المؤتمر، وعقد ورش عمل ولقاءات دائمة لتدارس المستجدات العلمية الحديثة ، وتطوير البرامج الأكاديمية التنافسية وحوكمتها في الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، والاستثمار في الكوادر البحثية وذلك من خلال إجراء البحوث البينية بين المتخصصين وبالشراكة مع المنصات العلمية العالمية ذات العلاقة لتبادل المعرفة والنشر.

اقرأ ايضا
آخر الأخبار